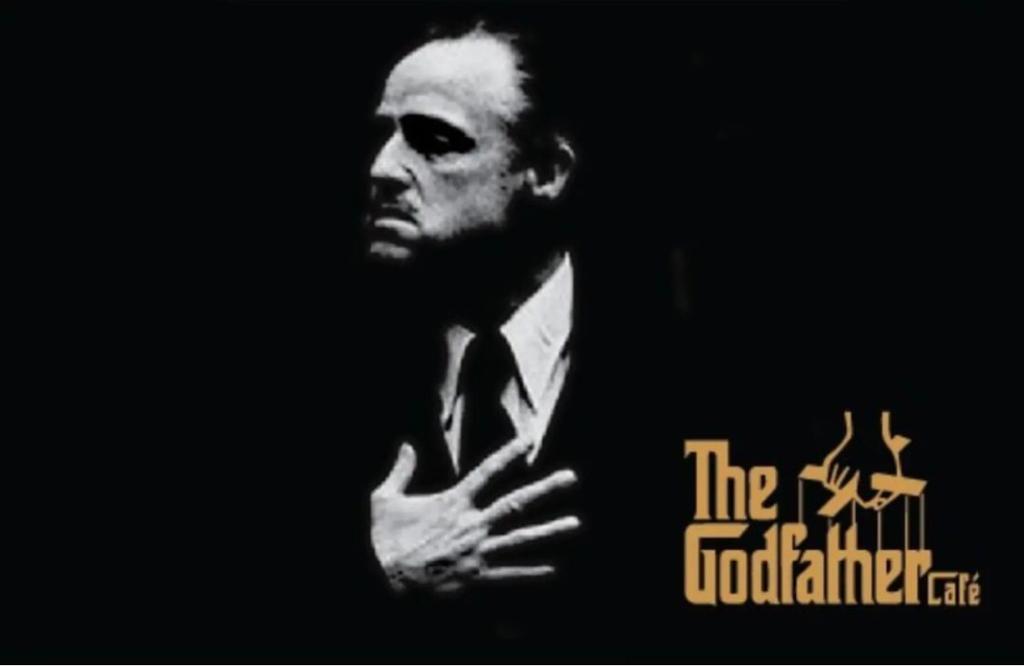لا يمكن اختزالُ حياة الرئيس حسين الحسيني بأنه «عَرّاب الطائف» وحافِظ أسراره ووثائقه فحسب، فرحيله أمس في وقتٍ يتهدد الخطرُ «جمهوريةَ الطائف» التي يَنْهَشُها الانهيار الكبير والشامل، يُعْطي لهذا الغياب معنى مزدوجاً، في الحالتين الإنسانية والوطنية.
رَجُلٌ خلوق ودمِث، وواحِد من رجالاتٍ قلة عرفهم الوطن الصغير ممّن لعبوا دوراً وطنياً. ينتمي إلى جيلٍ سياسي مثقّف ورصين ومهذَّب، وهي صفاتٌ لم تعد تليق بكثيرين من رجالات السياسة في «لبنان اليوم».
غالباً ما كان يسبق الجميع بالسلام والكلام وبالحفاظ على بروتوكلات اللياقة الاجتماعية التي ندرت عند السياسيين من حديثي النعمة. البقاعيّ الأصيل، السيد ابن بلدة شمسطار الذي انطبع بالصفاء والهدوء والاعتدال... حتى الرمق الأخير.
رغم اعتكافه السياسي، ظلّ الحسيني متابعاً حريصاً لمجريات الحدَث. يدقق، يتابع، ويتصل بأي كاتب أو صحافي أو سياسي، يسأل أو يصحّح معلومةً أو خبراً أو تحليلاً.
مرجعيةُ اتفاق الطائف، ومرجعيةٌ دستورية بالمعنى العملي، لم يكن ممكناً لأي مهتمٍّ بشؤون مجلس النواب وشجونه أن يتخطى فتواه الدستورية أو رأيه بأي مجرياتِ أحداثٍ لها صلة بالطائف، أو بتعديلاتٍ دستورية أو بدور مجلس الوزراء ومجلس النواب وتشريعاته.
المُدافِع الشرس عن الاتفاق التاريخي الذي أوقف حربَ لبنان، شهد العبثَ به على يد سورية التي كان قريباً منها استراتيجياً، لكنه تحوّلَ بفعل دورٍ مُتمايِزٍ حافَظَ عليه بعد عام 1992 يوم جرى الانقلاب عليه فأُبعد عن رئاسة المجلس النيابي لمصلحة الرئيس نبيه بري.
وقد يكون السرّ يومَها في لحظة إبعاده لبنانياً أو سورياً بفعل موازين القوى التي تبدّلتْ مع مجيء الرئيس الياس الهراوي والرئيس رفيق الحريري الذي خاصَمه بشدّة، وتبدّلتْ داخل سورية لمصلحة فريق آخَر أيّد ترويكا الهراوي والحريري وبري.
انتُخب الحسيني نائباً عام 1972 في آخِر دورة نيابية سبقتْ الحرب التي اندلعت عام 1975، وتحوّل تدريجاً واحداً من القيادات الأساسية التي يُعوَّل عليها لوأد الحرب. لم تدخل الطائفة الشيعية حينها الحرب بالمعنى القتالي والعسكري والميليشيوي، لكن الإمام موسى الصدر بتأسيسه «حركة المحرومين» بمشاركة الحسيني، فَتَحَ الباب أمام حركة «أمل» لتبدأ مسيرةً سياسية الى جانب المسيحيين والسنّة والدروز.
وكان الحسيني لاعباً فاعلاً إلى جانب الصدر في محاولاته الحوارية لوقف الحرب، وأراد أن تؤدي «أمل» دوراً فاعلاً للطائفة التي تعاني من الحرمان، قبل أن تخرج من رحمها حركة «أمل الإسلامية» ومن ثم «حزب الله». لكن الحركة انخرطت شيئاً فشيئاً في الحرب فاستقال من رئاستها عام 1980.
كان الحسيني رئيساً لحركة «أمل» بعد تغييب الصدر، وقت صعود نجم المحامي نبيه بري وتسلُّمه قيادتها ودخوله فعلياً الساحة العسكرية. وكان مجلس النواب يمدّد لنفسه دورةً تلو أخرى، وكان الحسيني نائباً يتصاعد دوره بقوة، في ظل رئاسة كامل الأسعد لمجلس النواب.
لم يكن الحسيني من طبقة شعبية. سيّد من الأسياد فاعلٌ في الساحة الشيعية، وصل تدريجاً لأن يكون بديلاً عن الأسعد عام 1984 في رئاسة البرلمان. لكن بقدر ما بدأ يلعب دوراً مميزاً في لجان الحوار وفي العمل السياسي والنيابي، كان نجم بري يتصاعد تدريجاً، إلى حد صوغه الاتفاق الثلاثي مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ايلي حبيقة برعاية سورية قبل أن يطاح بالاتفاق، ومشاركته مع القيادات الرئيسية من مختلف الطوائف في مؤتمريْ جنيف ولوزان.
على قساوة مرحلة الثمانينات وحروبها المختلفة الوجوه، من الاجتياح الاسرائيلي إلى حروبٍ داخلية، مسيحية - مسيحية وإسلامية - إسلامية، شكّلت نهاية هذه الفترة المرحلةَ الذهبية في تاريخ الحسيني السياسي. لأنه حينها برز دوره مُحاوِراً وسياسياً له امتداده العربي وعلاقاته السورية، ونجح في أن يتحول لاعباً أساسياً في التحضير ومواكبة اتفاق الطائف الذي أُبرم خريف 1989 وأقرت التعديلات الدستورية التي تَضَمَّنها في 1990.
هي المرحلة الأهمّ التي انطبعتْ بالاتفاق الأصعب الذي تم التوصل إليه برعايةٍ سعودية ومشاركة النواب اللبنانيين ومستشارين وشخصياتٍ برز دورها لاحقاً كالرئيس رفيق الحريري. علماً أن الامتداد العربي للحسيني، جعله واحداً من القيادات الشيعية التي ظلت على تَقاطُعٍ دائم مع دول عربية فاعلة، نَسَجَ علاقةً معها إبان الطائف لكن قبله أيضاً في لجان الحوار العربي ووفودها إلى بيروت.
ليس من السهل مطلقاً مقاربة دور الحسيني في الطائف، عبر تمكُّنه من أن يكون صلة الوصل بين المرجعيات في لبنان وفي السعودية ومع العواصم التي تتدخل في كل فاصلة ونقطة في اتفاقٍ تاريخي.
كُتب الكثير عن الطائف على لسان مُشارِكين فيه من نواب وسياسيين وصحافيين، وهناك نقطة إجماع تتخطى احتفاظ الحسيني بأوراق الاتفاق غير الرسمية والرسمية ونقاشاتٍ معمّقةٍ جرت بين مدينة الطائف ومكاتب مرجعيات في بيروت، لتتحدّث عن الدور الذي أداه في استيعاب انتقاداتٍ واتهامات ومطالب الأطراف جميعاً تحت ضغط الوضع العسكري والتهديدات التي كان يطلقها العماد ميشال عون ضد المجتمعين في الطائف.
عَرف الحسيني أن يختصر مع المستشارين الكثر الذين صاغوا عباراتٍ دقيقة في الاتفاق، الذي أحْدَث نقلةً نوعية في الدستور اللبناني عبر التعديلات التي أجريت عليه، مداولاتِ الأيام الصعبة على وقع ضغوط إقليمية وغربية لتسريع إنهائه ومن ثم العودة إلى لبنان وإقراره.
من الصعب تجاوز مرحلة الطائف التي شكلت على أهميتها بداية خروج الحسيني من دائرة الضوء، والتباس علاقته بسورية التي لم تكن مؤيّدة لانتخاب «رئيس الطائف» رينيه معوض الذي اغتيل في 22 نوفمبر 1989 (بعد 17 يوماً من انتخابه) وكان زكّاه الحسيني، ولم ترغب بالاتفاق ككل ولم تطبّقه لاحقاً. فهل دَفع الحسيني ثمن الاتفاق. إذ انها مفارقةٌ ان ينتهي دوره مع بدء مرحلة تطبيق دمشق نسخةً من الطائف وضعت فيها جانباً ما يعنيها وطبّقت وفق الضرورات ما تراه مُناسِباً لها.
حافظ الحسيني على صلات مهمة مع مختلف القوى السياسية والطوائف. وظلّت تربطه بالقوى المسيحية في زمن المعارضة لسورية علاقةٌ جيدة لا يعزّزها فقط وجود شقيقه النائب الراحل مصطفى الحسيني في الحلقات المعارضة المسيحية.
بل إنه حافظ على صلاته لا سيما في تقلُّده دور المُعارِض لسياسات الرئيس الحريري الاقتصادية ومعاركه المفتوحة معه تحت سقف معارضة سوليدير وسياسته الاقتصادية الى جانب نوابٍ معارضين مسيحيين. ورغم معارضته الشرسة أحياناً كثيرة للحريري وهو الزعيم السني رقم واحد في مرحلة التسعينات الى عام 2005 حين اغتيل، ظلت علاقة الحسيني بالمرجعيات السنية على قوّتها ولم يقطع أواصرها أيُّ اشتباكٍ سياسي.
في المقابل يشكل دخوله نائباً منفرداً الى المجلس النيابي منذ عام 1992 الى خروجه منه (بالاستقالة) عام 2008 إحدى العلامات الفارقة في الحياة السياسية الشيعية.
ولا شك أن التحول الشيعي الكبير بدخول حزب الله البرلمان بكتلة بقاعية بالدرجة الأولى وصعود الحزب كقوة في الحياة السياسية بعد بري وتشكيلهما ثنائياً، أزاح الحسيني من الواجهة.
لم يكن بري و«حزب الله» ليقبلا خطاً شيعياً ثالثاً، ولا سيما أن الحسيني عُرف باعتداله رغم مواقفه السياسية من سورية.
وهنا قد تكون نقطة خلاف مع الذين كانوا يرون أن الحسيني تقاعَدَ باكراً من الحياة السياسية ومن مواجهة الثنائي بعدما تيقّن أن لا مجال لمزاحمتها سياسياً، وتعاطى معهما كأمر واقع فتراجَع الى الصفوف الخلفية باكراً متيقناً أن موازين القوى الإقليمة غير مؤاتية.
وهو أعلن تقديم استقالته من مجلس النواب في أغسطس 2008، مستعيداً دور الإمام الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين والطائفة الشيعية التي آمنتْ «بلبنان الموحد بحدوده الحاضرة سيداً حراً مستقلاً عربياً في محيطه وواقعه ومصيره ويلتزم التزاماً كلياً بالقضايا العربية وفي طليعتها قضية فلسطين»، وانتقد ما يتعرض له الدستور إذ «لم أرَ في حياتي السياسية تمزيقاً في الدستور كهذا التمزيق. إنه أمر محزن استمرار هذا المشهد كأننا لم نتعلم من تجارب الماضي».
كان الحسيني ينتقد بشدةٍ ممارساتِ تطبيق الطائف وما يحصل من تهشيمٍ للدستور الذي أشرف على كتابة تعديلاته وآمَن به وحافظ على أسراره كما كان يردد بطلبٍ ممّن شاركوا فيه.
وهو انتقد مراراً «حزب الله» في تخطّيه دور المقاومة ضد إسرائيل، كما انتقد ممارساتٍ أدت الى أن تلعب الطائفة الشيعية دوراً مُغايراً لِما كان يريده الإمام الصدر.
جرت محاولاتٌ لعودته عن انكفائه عن الحياة السياسية في عام 2018 لكنها لم تثمر ترشّحه إلى النيابة التي اعتذر عنها.
وانحسر دوره في الأعوام الأخيرة، ليتحول علامة دستورية وناقداً للحياة السياسية ومؤرخاً لأهمّ مراحلها.
وأولاً وآخِراً مدافعاً في حلقات قانونية وجامعية وسياسية عن اتفاق الطائف وضرورة تطبيقه وعدم تعديله وقت تكاثرت الايحاءاتُ بأن الثنائي الشيعي يريد تعديله.
يغيب «أب الطائف» وعرّابه فيبادر الى نعيه خصومه قبل حلفائه في إجماعٍ على ان الرجل كان خصماً شريفاً، وإن حاداً، وكان جديراً بالاحترام الذي بادل به خصوم وقلّ نظيره في تَعامُل السياسيين اللبنانيين مع بعضهم البعض.